استقبلني هام ماي مجددًا في منتصف سبتمبر. كان مطر منتصف الموسم في الريف غزيرًا وممتدًا بعض الشيء، لكنه لم يكن كافيًا لمنع خطوات طفل بعيد عن الوطن من زيارته. بالنسبة لي، لا أعود إلى المنزل إلا ثلاث مرات في السنة، على الأقل ليومين، وعلى الأكثر لثلاثة أيام. ومع ذلك، في كل مرة أعود فيها إلى المنزل، يكون شعور الحنين في قلبي مختلفًا، يصعب وصفه.
عند ذكر بلدية هام مي تحديدًا ومنطقة هام ثوان نام عمومًا، يتبادر إلى ذهن الجميع فورًا "فاكهة التنين وفاكهة التنين" في بينه ثوان . لكن في الماضي، خلال فترة الدعم، كانت هام مي وتان ثوان وبلديتا المنطقة تتمتعان بظروف كافية من الأرض والمياه لزراعة الأرز على مدار العام. كانت أشجار الفاكهة خضراء وخصبة. عندما تذكرت أيامًا لم تكن فيها حدائق فاكهة التنين قد تطورت بعد، تذكرت منزل والديّ المسقوف بالقش وسط حديقة فاكهة خضراء على مدار العام. كانت حديقتي واسعة، وأشجارها خصبة وكثيفة، وممراتها متعرجة. كان الهواء في الحديقة منعشًا ومنعشًا دائمًا؛ في ذلك الوقت كنا نتنفس هواءً يملأ صدورنا بحرية. ربما الآن، بعد حياة طويلة في المدينة، كانت العديد من الطرق تعج بالناس نهارًا، وفي الليل كانت الأضواء تتلألأ بألوان زاهية، ومع صخب الحياة، نسيتُ أحيانًا الكثير من الذكريات. لكن عندما عدت إلى المنزل، ورأيت المناظر القديمة، بدت كل تفاصيل الحديقة التي نشأت فيها سليمة كما كانت من قبل. وقفت لفترة طويلة في المكان الذي اعتدت أن أمد يدي إليه عندما أستيقظ لأغرف مغرفة من الماء البارد من الجرة لأفرش أسناني وأغسل وجهي. أغمضت عيني، فرأيت نفسي أتسلق شجرة جوز الهند، وأقطف الأوراق وأزحف مباشرة إلى الأعلى، مستخدمًا قدمي لركل جوز الهند الذي تم بشره للتو في البركة بجوار السطح. ثم رأيت نفسي أحمل شعلة صغيرة، وأشعل الدخان على خلية نحل، مما يجعل النحل يطير بعيدًا، ثم باستخدام سكين خشبي لكشط كل الشمع والعسل في وعاء بلاستيكي؛ لقد لسعتني بعض النحل غير اللاسع حتى تورم ذراعي، لكنني كنت متحمسًا للغاية لشعور إحضار كأس إلى المنزل. كسرت الرياح عناقيد الموز التي امتلأت للتو عبر الشجرة. كنتُ أغطيها بأوراق الموز اليابسة، وأخرجها كل يوم لأتفقدها وأتناول ثمارها الناضجة... ثم وجدتُ نفسي أتسلق الشجرة العالية، أقطع سيقانها الطويلة العتيقة لجدتي، وأقطع السيقان الطويلة الجافة لأخزن الأرز لأيام رعيها للأبقار في الغابة طوال اليوم. فزعتُ عندما نادتني أمي: "ماذا تفعلين هنا بهذه الغفلة؟ لقد انطفأ البخور. تعالي وأشعلي بعض النبيذ والشاي لأبي، ثم أحرقي بعض القرابين الورقية لدعوة الضيوف لتناول الطعام والشراب، وإلا سنتأخر، وعلينا الاستعداد للعودة إلى المدينة."

كبرت معي أشجارٌ كالبابايا وجوز الهند والموز والتنبول والأشجار الباسقة المحيطة بالبركة في الحديقة، وأسرتني، وشاركتني قصصًا ومشاعر كثيرة. قضيتُ طفولتي في كوخٍ من القش، محاطًا بحديقةٍ خضراء طوال العام. لم يكن في المنزل موقد غاز، ولا موقد كهربائي، ولا مصابيح كهربائية، ولا تلفاز، ولا هاتف؛ كان هناك فقط موقد حطب ومصباح زيت. كل زاويةٍ صغيرةٍ في الحديقة، وحول الفناء، وعلى طول الطريق إلى الحقول والخنادق، منحتني ذكرياتٍ لا تُحصى، ذكرياتٍ بسيطةٍ وعزيزةٍ ونقيةٍ عن زمنٍ كانت فيه مدينتي لا تزال فقيرة. عشرون عامًا من التعلق بالريف ساعدتني على أن أكون أقوى خلال سنوات دراستي وعيشي في المدينة، التي لم تكن هادئةً وسهلةً على الإطلاق.
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، أعاد أهل قريتي أعمدة خشبية وألقوا بها في الحقول وحتى في تربة الحدائق. ثم غطت حدائق فاكهة التنين حقول الأرز تدريجيًا، مدمرةً بذلك المساحات الخضراء اليانعة عندما كان الأرز صغيرًا والحقول الذهبية عندما كان الحصاد على وشك البدء. في كثير من الأحيان، عندما أتذكر ذلك، كان صدري يؤلمني قليلًا. على مر السنين، تغير نظام الحياة القديم، واختفت تدريجيًا الحقول الطميية والأراضي الفارغة التي كانت مرتبطة بطفولة الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة كل يوم ويرعون الأبقار كل يوم مثلي. توفي كبار السن والبالغون من حولنا تدريجيًا وفقًا لقانون الحياة، ولم يكن أمام الناس سوى الشعور بالحزن والحنين اللامتناهي كلما تذكروهم.
في الأيام التي أزور فيها مدينتي، أجدادي ووالديّ، غالبًا ما أقضي وقتًا في زيارة أماكن مألوفة على أرض أجدادي، حيث نشأوا، وأتأمل السماء المألوفة بدموع. في مثل هذه الأوقات، أرغب دائمًا في إحضار شيء من هنا إلى المدينة كتذكار. لأنني أعلم، بعد فترة وجيزة، عندما أصبح عجوزًا، حينها، حتى وإن كان قلبي لا يزال يحب ويتذكر ويندم ويعتز بالأشياء النقية، فسيكون من الصعب عليّ رؤية أجدادي ووالديّ والمشهد القديم في كل مرة أعود فيها لزيارة مدينتي.
مصدر

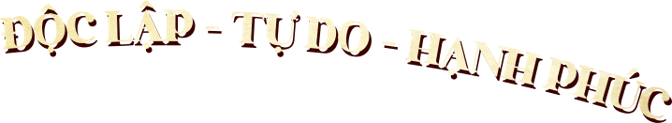


![[صورة] اصطف الناس بفارغ الصبر للحصول على الإصدارات الخاصة من صحيفة نهان دان](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/53437c4c70834dacab351b96e943ec5c)
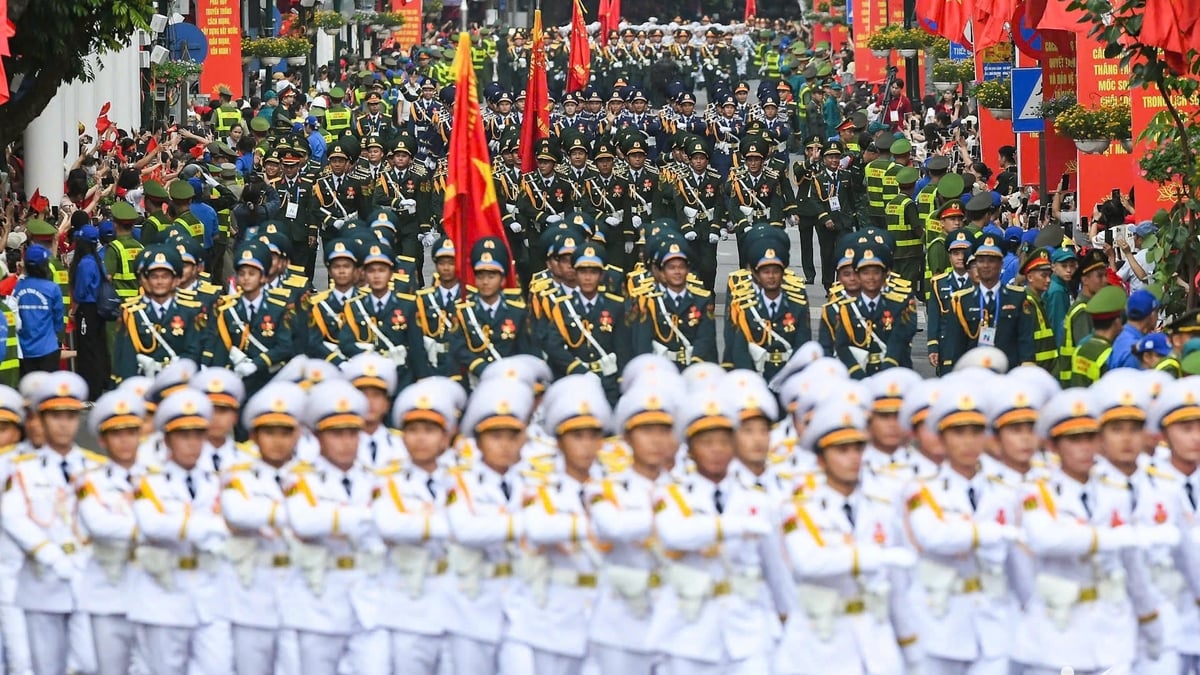



















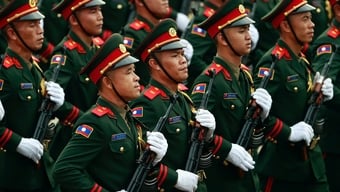







































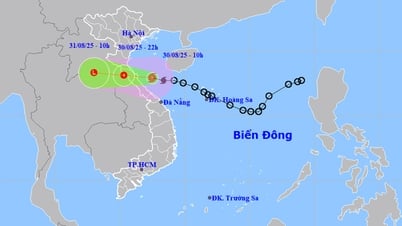





































تعليق (0)